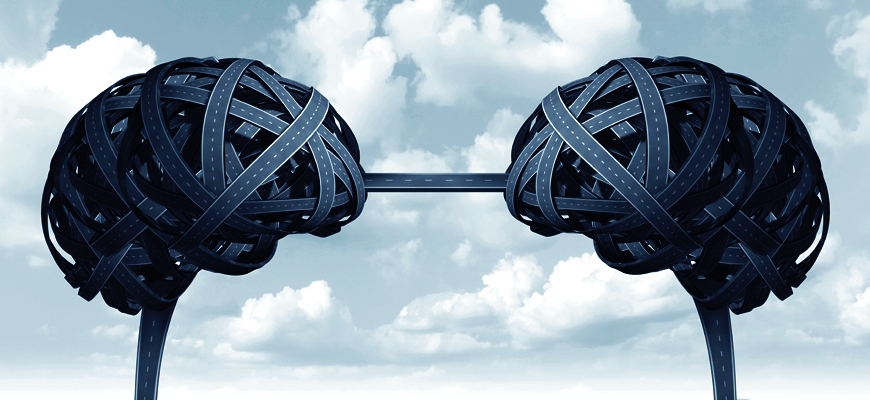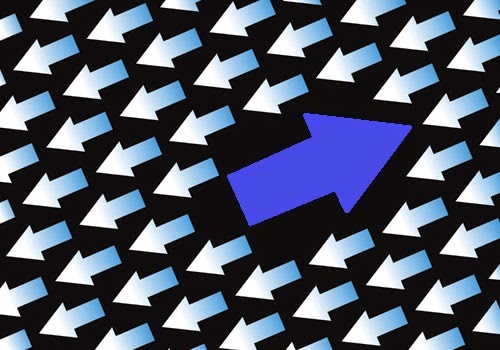إن ما انتهينا إليه في الكلمة الماضية من كون المجاهدة –سواء أكانت في مواجهة النفس أم كانت في مواجهة الموضوع المقصود بالفهم– هي بيت القصيد ونقطة الارتكاز في دفع المخاطر التي تتهدد رحلة الفهم، أقول: إن هذا الذي انتهينا إليه آنفًا يجعل العمل التزكوي (نسبة إلى التزكية) مقومًا أصيلًا من مقومات تحقيق الفهم والحفاظ على استقامته، إذ إن العمل التزكوي –بوصفه اجتهادًا في التعبد لله قلبًا وقالبًا– يُفضي إلى تقويم النفس ومعالجة شرورها.
وعليه، فما أسعى إليه هنا أن أُبيّنَ كيف يتولّى العملُ الشرعيُّ التزكويُّ –بطبيعته العمليّة وخلفيّته الأخلاقيّة– ضبطَ “حدث الفهم” الذي يبدو في ظاهره ذا طبيعة عقلية نظرية مجردة.
أُسارع وأُنبّه إلى أمرين:
الأول: إنّ ما أسعى إلى بيانه يتجاوز السرديات التقريرية المُجملة، التي يُقدّمها الوعّاظُ الأفاضلُ عن قيمة “التزكية” في تحقيق الهداية والرشاد، دون تحليل دقيق منهم لحيثيات تحقيق العمل التزكوي لتلك الهداية وذلك الرشاد عمومًا، وعلى مستوى “حدث الفهم” الذي يمثل موضع اهتمامي هنا خصوصًا.
الثاني: إنّ “العمل التزكوي” المقصود من كلامي هنا، العمل البريء من آفات العمل الشرعي التي سبق أن تعرّض لها كلامي، وهي: ادعاء التملك للعمل والتميز به، إذ إن هذه الآفات مُعطّلة لمردودية العمل التزكوي بإفسادها لرُوحه، وهذه المردودية المطلوبة من العمل التزكوي هي المُسدِّدة لـعملية الفهم، فإذا تعطّلت تلك المردودية –بسبب الآفات– صرنا مع عمل تزكوي دون تسديد، فصار العامل والعمل فتنةً ومحنةً أكثر منهما هدايةً ومنحةً.
إن الوعي بهذا الدور التسديدي لـلتزكية في إيقاع حدث الفهم، لَهو أمرٌ في غاية الأهمية، على أكثر من مستوى، على النحو التالي:
أولًا: إن غياب هذا التحليل العلمي الدقيق لأثر التزكية في تحقيق الفهم –في وقت سيطرت فيه الأسباب المادية على أساليب تفكيرنا النظرية وممارساتنا العملية من جهة، وادّعاءات التملك للعمل الشرعي والتميّز به من جهة أخرى– طَمَسَ قيمةَ “التزكية”، سواء أكان هذا الطمْسُ بالتقليل من قيمتها عند الماديين أم كان بجهل الآفات المصيبة لها عند المُدّعين للتميز بالعمل الشرعي، وهو ما أوهم هؤلاء المُدّعين تحصيل التزكية، فصاروا فتنة للناس، إذ إنهم بأفعالهم الجاهلة –المبنية على وهمَي التملك للعمل الشرعي والتميز به– يطمسون قيمة التزكية في وعي الناس، إذ إن الناس ترى ادّعاءً للتزكية ولا ترى أثرًا لها.
ثانيًا: إن هذا الفصل بين التزكية والفهم سطَّحَ عمليةَ الفهم وعرّضَها لداء عُضال عند الفريقينِ، ألا وهو: الازدواج الخُلُقي، بمعنى أن الفهم صار ذا بنيتين: الأولى ظاهرة: يدّعي صاحبُها قيمَ الحقِ والفضيلةِ وتحري الموضوعية ورفضِ الذاتية، والثانية خفية تموج بالثارات النفسية والعصبية الشخصية والتقديرات الذاتية التي تتلون بألوان عدة؛ دينية تارة وعلمية أخرى، بيد أنها –في حقيقتها– لا شأن لها بالدين أو العلم من قريب أو بعيد، وهو ما صيّر الفهم في ظاهره “تدبيرَ سِلْمٍ”، وأما باطنُه فـ”تحضيرُ حربٍ”.
ثالثًا: سيرفع هذا الوعيُ بالصلة بين التزكية والفهم –مستوى الالتزام بالمبادئ التي سبق أن سقتها، بوصفها دليلًا للوقاية من المخاطر التي تتهدد عملية الفهم في الكلمة الماضية– من مستوى مبادئ نظرية ذات طابع فكري نظري مؤقت إلى مستوى مبادئ أخلاقية ذات أصل شرعي عملي مستمر، وهو ما يجعل الإلزام بها أعمق وجودًا وأقوى أثرًا، إذ إنه إلزام داخلي يمارسه الإنسان إزاء روحه وربّه أكثر منه إلزامًا ظاهريًا يقبل الوقوع في أسر النفس والاختزال، فيدّعيه المرءُ أمام الآخرين ثم يفعل بعد ذلك ما يحلو له، ومن ثم يكون في عقد هذه الصلة بين التزكية والفهم دواءٌ لـلازدواج الخُلُقي المرصود آنفًا.
رابعًا: إن الوعي بهذه الصلة بين التزكية والفهم سيجعل حدث الفهم دومًا واقعًا في رعاية مفاهيم أخلاقية هادية له، هي: “المسؤولية” و”الأمانة”، وهي مفاهيم ذات طبيعة عملية أخلاقية أكثر منها نظرية فكرية، وعليه فمِنْ شأن اعتبار هذه المفاهيم أن يخرج الفهم من صبغته النظرية الفكرية، فتجعل هذه المفاهيمُ الفهمَ فهمًا أخلاقيًا، بمعنى أنه فهم أمين فيما يحاول فهمه، كما تجعل هذه المفاهيمُ الفهمَ فهمًا عمليًا، بمعنى أنه فهم مسؤول فيما يُرتِّبه من عمل على هذا الفهم المُنتَهى إليه عند صاحبه، فلا ينغلق هذا الفهمُ في التشخيص النظري للمشكلات دون طرح للحلول العملية البديلة والحقيقية لتلك المشكلات، إذ إنّ في ذلك إخلالًا بالأمانة وعدمَ تقديرٍ للمسؤولية.
حتى يتسنى لنا كشف هذا الدور الذي يؤديه العملُ التزكويُّ إزاءَ حدثِ الفهمِ تقويمًا وتسديدًا، لا بد أنْ نُميط اللثام عن ثلاثة أمور: الأول: معرفة نقاط القوة التي يتميز بها العمل التزكوي، الثاني: الوقوف على نقاط الضعف المبثوثة في حدث الفهم، الثالث: أنْ نُبيّنَ كيف تكون نقاطُ القوة بالأمر الأول (العمل التزكوي)، دواءً فريدًا في نوعه وناجعًا في أثره، لنقاط الضعف بالأمر الثاني (حدث الفهم).
سرابُ الموضوعيّة
سأسعى هنا إلى إنجاز الخطة التي افترضتها للوصول إلى حقيقة مفادها أن التزكيةَ بالعمل الشرعي الضمانةُ الوحيدة لتحقيق الفهم الصحيح المأمون، وذلك عن طريق: كشف نقاط الضعف المتأصّلة في عملية الفهم، ثم بيان كيف تكون التزكية دواء فريدًا ووحيدًا لها، بادئًا هنا بالحديث عن نقاط ضعف عملية الفهم.
إن كشف نقاط الضعف المبثوثة بـحدث الفهم مرهون بوعي أن عملية الفهم –بوصفها إدراكًا لعلاقة بين أمرين أو أكثر– تنهض على ركنين: الموضوع المفهوم، والذات الفاهمة، وأن هذينِ الركنينِ يُعانيانِ عجزًا متأصّلًا في كل واحدٍ منهما عن تحقيق الموضوعية ونفي الذاتية في الوصول إلى المعنى الذي يُمثّل ناتج عملية الفهم.
سأسعى في هذه الكلمة للتدليل على هذا العجز المتأصّل في طبيعة هذينِ الركنينِ بالحديث عن أمرين:
الأول: يتعلق بسمة متأصّلة في طبيعة موضوع الفهم، وهي ما سمّيتها بـتراتبية علاقات موضوع الفهم.
الثاني: يتعلق بسمة متأصّلة في طبيعة الذات الفاعلة للفهم، وهي ما سمّيتها بـتكاملية جوانب الذات الفاهمة.
لنصل عبر هذينِ الأمرينِ إلى نقطة الضعف المتأصّلة في عملية الفهم تلك، التي تمثل مقصدي الأصلي بالكلام ها هنا، وسنعرف لاحقًا كيف تكون التزكية هي الدواء الوحيد والفريد لـنقطة الضعف المنتهى إليها هذه.
من ثم سيدور كلامي على ثلاث نقاط:
الأولى: تراتبية علاقات موضوع الفهم وأثرها على تعدد المعنى المنتهى إليه.
الثانية: تكاملية الذات الفاهمة وأثرها على حتمية تحيّز الفهم.
الثالثة: نقطة ضعف عملية الفهم.
أولًا: تراتبية علاقات موضوع الفهم وأثرها على تعدد المعنى المنتهى إليه
1- إذا كان الفهم إدراك الإنسان لارتباط موجود بين شيئين أو أكثر، أي للعلاقة بينهما، فإن عقل الإنسان –في نهوضه لإدراك أمر ما– لا يدركه على نحو مجرد خالٍ من التوجيه، إذ إن عقل المرء ليس آلةً صماء لا دورَ لها إلا أن تُسجّل ما يأتيها من خارجها، أو صفحةً بيضاء يُكتب عليها ما تُحصّله حواسُّه بشكل مجرد، لكن العقل يدرك هذه العلاقة تحت توجيه أمور عدّة، هي: معارف مؤسِّسة، وخبرات سابقة، وأهداف متوخاة من عملية الفهم.
2- إن هذا الكلام يعني أن عملية الفهم وإنْ بدتْ في ظاهرها تسجيلًا حياديًا لعلاقة بين أمرين أو أكثر، إلا أنها في عمقها إذعان اضطراري لسلسلة من العلاقات الأخرى المضمرة والمفترضة، ووجود هذه العلاقات المضمرة إنما يعني أنّ كل فهمٍ لشيءٍ ما يعتمد على فهمٍ آخر مُسْبَقٍ، إذ إنه لا يمكن للإنسان أن يفهم شيئًا ما وهو يضرب صَفْحًا عن كل ما يعرفه، فالذهن لا يمكن أن يبني فهمه للأشياء في انفصال تام عن معارفه السابقة وخبراته المتحصلة، وهذا ما أقصده بـتراتبية علاقات موضوع الفهم، بمعنى أن فهم شيء ما يترتب على فهم أشياء أخرى، ومن ثم فالتصورات والرؤى التي يلقيها المرءُ إزاء الوقائع والنصوص –إنْ بدت في ظاهرها أحكامًا مفردة مجردة– في عمقها انعكاسٌ لمنظومة عقلية تصورية تتشكل من مجموعة من الأفهام متساندة الأفكار ومتعاضدة الأركان.
إنّ تحكُّم هذه المنظومة الخفية في رؤى القائم بـعملية الفهم جعل بعض الدارسين يقول: “إن الإنسان لا يتعرّف على موضوعه بقدر ما يتعرّف على نفسه عند تعرّفه على موضوعه”.
3- إن هذه التراتبية –المتأصلة في طبيعة علاقات موضوع الفهم– تُحتم ألا يكون المعنى –الذي يسعى الإنسان بـعملية الفهم لاستخلاصه– معطى جاهزًا يلتقطه عقلُ الإنسان مما هو ماثل أمامه، بقدر ما يكون هذا المعنى نتيجة بعديّة يبنيها الإنسانُ في ضوء معارفه، وخبراته، وأهدافه العميقة التي تُحرّك عملية الفهم عنده.
وعليه فليس الفهم عملية كشفية يُكتشف بوساطتها المعنى المنتَهى إليه كما تُكتشف المعادن بباطن الأرض، لكنه عملية بنائية يُبنى بوساطتها المعنى المنتهى إليه كما تُبنى البنايات.
إن هذه البنائية في طبيعة المعنى المنتهى إليه تجرّنا إلى حقيقة أخرى، مفادها إمكانية تعدد صور بناء هذا المعنى، نظرًا لتعدد الأمور التي تُحرّك عملية الفهم، تلك الأمور التي سردتها آنفًا، ومن ثم فليس الفهم قبضًا على المعنى بقدر ما هو صناعة له، عن طريق خلق وقائع فكرية (أطروحات نظرية = نماذج) تُعيد رسم المعنى وتوزيع عناصره، بعبارة مختصرة: الفهم بناء لنموذج يعيد تشكيل المعنى بصورة تخلق وقائع فكرية جديدة تغير وجه الواقع.
4- إن تراتبية علاقات موضوع الفهم على نحو ما أوضحتُ من جهة، وبنائية المعنى من جهة أخرى، وتعدد صور بناء المعنى من جهة ثالثة– تجعل من تعدد المداخل النظرية الممكنة على موضوع الفهم أمرًا حتميًا من ناحية نظرية مجردة.
5- من ثم تقف تراتبية علاقات موضوع الفهم وما يلزم عنها من تعدد صور بناء المعنى المنتهى إليه، وما ينتج عنها من إمكانية تعدد المداخل الممكنة على موضوع الفهم– تحديًا كبيرًا في مواجهة الموضوعية، التي تعني الوصول إلى الفهم الأصوب والمعنى الأدق إزاء الموضوع المقصود بالفهم، إذ إن كل هذه الأفهام المتعددة –من ناحية نظرية صرف– تقف على قدم المساواة.
إن ما أريد الانتهاء إليه من كلامي هنا: أن موضوع الفهم بنفسه وفي نفسه –من ناحية نظرية مجردة– لا يملك بوصلة تحدد أي الأفهام المطروحة إزاءه هي الأصوب، ومن ثم أي أساليب مقاربته هي الأوفق، دون قيمة تكون مُنظِّمة له ومُحدِّدة لما يستحق أن يأتي أولًا وما يأتي متأخرًا.
إن منبع هذه القيمة المُنظِّمة لموضوع الفهم، ومن ثم المُرجِّحة لفهم على آخر، هو الذات الفاهمة، ومن ثم يكون لهذه الذات الفاهمة مركز الثقل في إدارة عملية الفهم، إذ إنها المسؤول الأول عن رفع هذا التحدي المتمثل في تعدد الأفهام الممكنة إزاء موضوع الفهم بسبب طبيعة موضوع الفهم التراتبية.
فهل يا تُرى تستطيع تلك الذات الفاهمة النهوض بهذه المسؤولية بمفردها؟! بعبارة أدق: هل تمتلك تلك الذاتُ الفاهمة القدرةَ الكاملة على التجرُّد من ثقل خصوصيتها الوجودية من ناحية، وأسر نموذجها المعرفي من ناحية أخرى وحدها، ومن ثَمَّ تحديد أي الأفهام هو الأصوب؟!
إن هذا السؤال ينقلنا إلى الحديث عن تلك الذات الفاهمة وما يواجهها من تحدٍّ في سبيل تحقيق الموضوعية في بناء الفهم وتشكيل المعنى.
عندما تكون الموضوعيةُ مطيّةَ الفتكِ
ثانيًا: تكاملية الذات الإنسانية وأثرها على حتمية تحيّز الفهم
إن مركزية الذات الفاهمة في إدارة عملية الفهم –على نحو ما انتهينا إليه سابقًا– تحتم علينا أن نضع هذه الذات تحت المجهر، لنعرف مدى إمكانية وفائها بمهمة الحياديّةِ التي يفترضُها القولُ بـالموضوعيّة، إذ إننا سنعرف أن هذه الذات مقتحَمة من جهتين:
(أ) الطبيعة التكاملية لتكوين الذات الإنسانية.
(ب) طبيعة فعل الفهم الذي يمثل أداتها في استخلاص المعنى.
من ثم فهاتانِ الجهتانِ تجعلانِ المعنى المنتهى إليه من عملية الفهم، دومًا مُتْخَمًا بـالتحيُّز، وسنتوقف مع كل جهة منهما، لنرى مصداق ذلك القول، على النحو التالي:
(أ) الطبيعة التكاملية لتكوين الذات الإنسانية
إن تقسيم الذات الإنسانية إلى أقسام شتى: عقل ووجدان وحس وشعور، أو تقسيم أفعالها إلى: نظر وعمل، تقسيم نظري لا يُعبِّر عن الواقع العملي لهذه الذات الإنسانية، بقدر ما يُعبِّر عن افتراض تحليلي عند دارس هذه الذات، وسبب عدم واقعية هذا التقسيم أمران:
1- وحدة هذه الذات التي تنبع منها تلك الأقسام على تنوعها، تلك الوحدة التي تحتم وجود نوعٍ من التساند، أو التضافر بين هذه الأقسام، بمعنى أنّ هذه الأقسام متأثِّرٌ بعضها ببعض، وهذا التساند بين هذه الأقسام هو ما أقصده بـالطبيعة التكاملية للذات الإنسانية.
2- أن التجربة الحياتية التي تخوضها تلك الذاتُ الإنسانية مستخدمةً إحدى هذه القوى أو الأقسام المفترضة– لا تعرف التجزيء أيًا كان مجال هذه التجربة، وهو ما يُلزم بنشوء نوع من التفاعل بين هذه القوى أو الأقسام، حالَ قيام كل قسم منها بدوره المنوط به داخل التجربة الإنسانية.
بل إن هذه النزعة المُفرِطة في تجزيئية الذات الإنسانية وتجربتها الوجودية إلى نطاقات منفصلة ومستقلة– نزعة يونانية بالأساس وافدة على تراثنا وفكرنا، أنكرها علماء مسلمون، نظريًا، كابن تيمية وفخر الدين الرازي باستشكالاتهما على بعض مُسلّمات المنطق الأرسطي، وأنكرها الصوفية، عمليًا، بربطهم السلوكي الدائم بين الظاهر والباطن، وكان ذلك الإنكار لعدم واقعية هذه النزعة التجزيئيّة إنسانيًا من جهة، وعدم تماشيها مع عمق معارفنا الإسلامية وشموليتها التي تربط العلم بالعمل من جهة أخرى.
من ثم فتصوّر استقلالية هذه الأقسام بالأدوار المسندة إليها تصوّرٌ غير دقيق، وخطورة هذا التصور لا تتوقف عند عدم دقته، لكنها تتجاوز ذلك إلى إحداث تصوّرات كارثية في نتائجها، سأسرد بعضها –لتعلقها بادعاء الموضوعية الذي يهمني بالأساس– على النحو التالي:
1- إن الآخذ بهذا التصور المُفرِط في تجزيئيته للذات الإنسانية سيطمسُ كليةَ قوى الذات الإنسانية، ومن ثم سيغفل عمّا بين هذه القوى من تأثير متبادل على نحو ما أشرتُ.
2- ستمهد هذه الغفلةُ الأرضَ لإسناد أدوار مستقلة لتلك القوى، ومن ثم إمكانية اختزال شمولية هذه الذات الإنسانية في إحدى هذه القوى، كما حدث ذلك –بالفعل– مع “أرسطو” الذي حمله اهتمامه الزائد بـالعقل على اختزال قوى الذات الإنسانية المتعددة في العقل، وذلك باعتباره العقلَ جوهرَ الإنسان، أي: أساسه ولُبّه، وهو ما يشي بهامشية القوى الأخرى.
3- إن خطورة هذه التصورات الآنفة –من جهة اهتمامي هنا حيث الوعي بمدى قدرة الذات على تحقيق الموضوعية– إنما هي في: اعتقاد قدرة العقل –الذي اُختُزلت فيه الذات الإنسانية– على تحقيق الموضوعية والحيادية دون تشويش أو تأثير من الجوانب الأخرى التي أُهملتْ أو اُختُزلتْ في تكوين هذه الذات الإنسانية، وهذا التصوّر محض وهم وخيال، إذ إن صاحب هذا التصور المزعوم لا يلتفت إلى أنّ فرضية استقلال العقل عن الذات في إنشاء العقل لأحكامه، تلك التي تأسَّسَ عليها حكمُه بحتمية الموضوعية، هي فرضية غيرُ مُسَلَّمٍ بها أصلًا في ضوء الوعي بتكاملية قوى هذه الذات الإنسانية والتأثير المتبادل بينها.
خطورة هذا الوهم المُدَّعى والخيال المُفترَض، أنه سيجعل من مقولات: الموضوعية والحياد والعقل، مطيةً أَمُونًا وغطاءً متينًا لأهواء النفس وأمراضها، التي حتمًا ستُلوّن هذا العقل المُدَّعى أو تلك الموضوعية المزعومة دون أن يشعر صاحبها، خاصةً وموضوع الفهم قابل لتعدد النماذج المُفسّرة له وتباين المداخل المؤدية إليه على المستوى النظري كما عرفنا من الكلمة الماضية، كل هذا دون أن يشعر صاحبُ هذه الذات بآفات موضوعيته، تأملوا الخطورةَ!
(ب) طبيعة فعل الفهم
إن هذه التكاملية في طبيعة الذات الإنسانية تجعل فعل الفهم مجذوبًا دومًا –في سعيه لاستخلاص المعنى– نحو تحقيق التناغم بين أقسام هذه الذات من عقل وحس ووجدان، أكثر منه مُلتزِمًا بالوفاء بـخصوصية موضوع الفهم أو الاستجابة للتحدي المفروض على موضوع الفهم في الواقع العملي.
سبب انجذاب فعل الفهم نحو إحداث التناغم الداخلي عند الذات الفاهمة على حساب الموضوع المفهوم وما يواجهه من تحدٍّ، أن فعل الفهم لا يقع من الإنسان بوصفه نتيجة نظر مجرد، لكن بوصفه ثمرة ذات كلية يتشابك فيها ما هو وجداني مع ما هو عقلي، وما هو نظري مع ما هو عملي، وما لدى هذه الذات من قدرة على الفعل والبذل مع ما لديها من آمال وطموحات، وما هو حسي ظاهر مع ما هو باطني خفي، ليكون المعنى المنتهى إليه محصلة كل ذلك التشابك.
إن وقوع فعل الفهم تحت وطأة تشابك قوى الذات (تكامليتها)، يجعل الموضوع المفهوم مركوبًا لا راكبًا مقودًا لا قائدًا، إذ إن الذات الإنسانية –جِبِلَّةً– لا يمكن لها أن تفهم شيئًا ما فهمًا يكون مُحطِّمًا لجانب من جوانبها، فعلى سبيل المثال: لا يمكنني أن أفهم سوء حالي العلمي بشكل يفضح عجزي على صعيد من أصعدة حياتي، لذلك ألجأ دومًا إلى فهم يسمح لي أن أُحمّل جهلي لغيري، وإلا تحطّمتُ داخليًا، وهكذا دواليك على مختلف الأصعدة الوجودية للمرء من مادية واجتماعية وسياسية، وهلُمَّ جرًّا.
الأمر الذي يعني أن فعل الفهم –في إنتاجه للمعنى– متأثر حتمًا بتلك الجوانب الوجدانية والنفسية، وما يدخل عبرها من تصورات ثقافية واجتماعية ومعرفية، وما يرافقه من حالة وجودية، وهو ما يشكل تهديدًا حتميًا لموضوعية عملية الفهم وما تثمره من معنى، وهو ما ينقلنا إلى تركيز الحديث عن نقطة ضعف عملية الفهم.
ثالثًا: نقطة ضعف عملية الفهم
إن ما وصلنا إليه من حتمية تدخل قوى الذات القائمة بـعملية الفهم على اختلافها في ناتج هذه العملية عن طريق: حتمية تكامل قواها من جهة، وطبيعة فعل الفهم من جهة أخرى، إنما يعني أن الذات الفاهمة في حد ذاتها تشكل التحدي الأكبر لموضوعية عملية الفهم، ونقطة الضعف الأخطر في مسار تحقيق حيادية المعنى.
ويزيد من صعوبة هذا التحدي ثلاثة أمور:
الأول: أن فعل الفهم بوصفه تدبيرًا يأتيه الإنسان ويُنظّمُ حلقاته على جهة الترتيب والتعديل– يُرسّب في دواخلنا تصورات خالية من القيم الأخلاقية الإلهية، بمعنى أننا نتصور ولو بقدر قليل أن المسألة مسألة أسباب مادية أو أمور ظاهرية فقط، فضلًا عما يثمره هذا التدبير من إيهام لنا بأن فعل الفهم صادر عن أنفسنا، وهو ما يزيد من قوة حضور هذه النفس حال السعي المعرفي نحو تحقيق الفهم، هذا الحضور النفسي يُشكل عائقًا في مواجهة تحقيق الفهم، إذ إن النفس حينما تحضر معرفيًا تحضر بتحيزاتها، كأن إجراء عملية الفهم –منقطعةً عن القيم الإلهية المُوجِّهة لها والمُرشِّدة لحركة إجراءاتها– محكوم عليه حتمًا بـالذاتية من داخله، ومهدّد دومًا بـعدم الموضوعية.
الثاني: طبيعة المعرفة العلمية، إذ إن العلم بأدواته ومناهجه التي تُمثّل وسيلة الذات في مقاربة موضوعها– يعد مجالًا طيّعًا لكل استخدام ممكن خيّر أو شرير، فيمكن أن يستخدم العلم بترسانته لأهداف مختلفة وبطرق متباينة، فليس ثمة ما هو متجذّر في طبيعة العلم ويفرض عليه أن يُوظّف في استخدام معين، وهو ما يعني أنه بوسع الإنسان مهما تسلح بمناهج ومعارف أن يلوي عنقها خدمةً لأغراضه بشكل أو بآخر.
الثالث: طبيعة هذه الذات الإنسانية القائمة بالفهم، إذ إن هذه الذات لا تكفُّ عن المراوغة والتفلُّت والانثناء على نحو لا يشعر به صاحبها، ومن ثم إمكانية تحوّل عملية الفهم وموضوعها من سبيل استبصار للحق والفضيلة إلى مادة استثمار لأهواء وأغراض شخصية يغفل عنها فاعل الفهم نفسه.
إنّ هذا التحليل الذي انتهينا إليه يصل بنا إلى حقائق عدّة، يحسن إبرازها، على النحو التالي:
1- إنّ الاكتفاء بالتحليلات الخطابية والتنظيرات المُحذِّرة من عدم الموضوعية وخطورة الذاتية– ليس له أية قيمة حقيقية، إنْ كانت هي قُصارى ما يأتيه الإنسان.
2- إنّ الفهم رهان على تحييد الشر الكامن في ذات الفاهم، أكثر منه رهانًا على الإحاطة بموضوع الفهم، إذ إن عمق موضوع الفهم وتعدد إمكانيات طرحه وتناوله –كما بينتُ ذلك في تراتبية الفهم– تجعل من الإحاطة دومًا أمرًا نسبيًا وهو ما يجعل رحى موضوعية الفهم دائرةً على كيفية مداواة الشر الكامن بالذات القائمة بالفهم أكثر منها دائرة على الإحاطة بموضوع الفهم.
3- إنّ تحييد الشر الكامن في هذه الذات، لتحقيق الموضوعية، لا يمكن أن يتحقق من داخل هذه الذات، إذ إنها لا تملك القدرة على ذلك خِلْقةً وجِبِلَّةً بسبب تكامليتها، وإنما يتحقق ذلك عن طريق إخضاع هذه الذات لقوة أكبر منها تقع خارجها.
4- إنّ “العنف المقدس” لا يقتصر على العنف الذي يمارسه البعض تحت قداسة الدين، لكنه يشمل العنف الذي يمارسه آخرون تحت قداسة العقلانية المختزلة، أو بريق الموضوعية المسكونة بآفات النفس والهوى.
بعبارة موجزة: مهما أوتيت عملية الفهم من أدوات معرفية، وتوافر لها من رغبات خيّرة، فلن تكون بمأمن من هوى النفس، ما لم تستمد أنوار هدايتها من قوة أكبر.
انتهى
مقالات ذات صلة:
الجزء الأول من المقال، الجزء الثاني من المقال، الجزء الثالث من المقال
الجزء الرابع من المقال، الجزء الخامس من المقال، الجزء السادس من المقال
الجزء السابع من المقال، الجزء الثامن من المقال، الجزء التاسع من المقال
الجزء العاشر من المقال، الجزء الحادي عشر من المقال، الجزء الثاني عشر
* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
_________________________________
لمتابعة قناة اليوتيوب لأكاديمية بالعقل نبدأ، اضغط هنا
لقراءة المزيد من المقالات، اضغط هنا