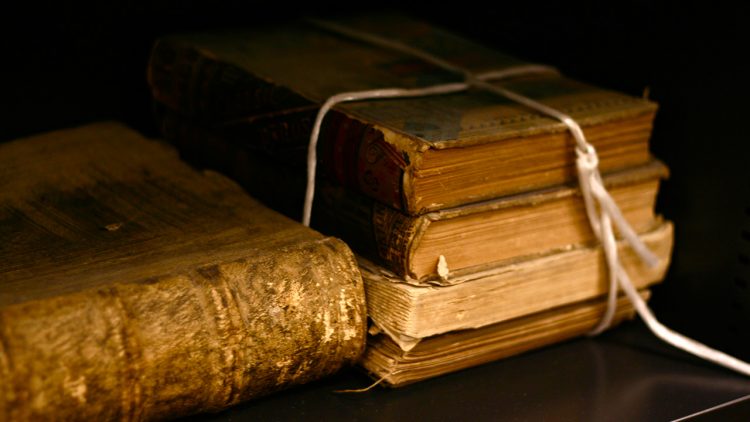هل هناك قطيعة إبستمولوجية في الفكر العربي؟

شهد العالم والفكر الإنساني ظهور عديد من المفكرين والمصلحين والمدارس الإصلاحية، أمثال جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا وغيرهم.
حاول هؤلاء تشخيص الأزمة التي تعاني منها مجتمعاتنا في القرنين السابقين، وبذلوا جهودًا مقدرة في حلها، وقد تناولت تشخيصاتهم وخطاباتهم وأدواتهم ومناهجهم الإصلاحية.
ركزت بعض الحركات الإصلاحية على الجانب التربوي، وبعضها على الجانب السياسي، وأخرى على الجانب العقدي الفكري.
هناك بعض التيارات نظرت إلى هموم المجتمعات وأدواتها ضمن الظاهرة الإنسانية العالمية، وموقع الإنسان من الحراك في الفكر العالمي، ومدى إسهامه في بناء الحضارة الإنسانية وترشيدها.
فهل هناك ما نطلق عليه اليوم قطيعة في الفكر؟
تعريف الإبستمولوجيا
تعني الإبستمولوجيا دراسة مبادئ العلوم وفرضياتها ونتائجها دراسة نقدية توصل إلى إبراز أصلها المنطقي وقيمتها الموضوعية، مفهوم الإبستمولوجيا علم العلوم من حيث الدلالة اللغوية، أو علم المعرفة من حيث النقد والمنهج، وأيضا نظرية العلم، والدرس النقدي لمبادئ مختلف العلوم وفرضياتها ونتائجها، الرامي إلى تحديد أصلها المنطقي وقيمتها ومداها الموضوعي.
كيف تطورت الإبستمولوجيا؟

بين الماضي والحاضر
ليست هناك قطيعة حاسمة ونهائية، ولكل فترة من تاريخ المعرفة العلمية عوائدها الخاصة، وعندما تحدث قطيعة إبستمولوجية داخل فكر علمي يكون فكرًا علميًا جديدًا، فمثلًا يرى “كونت” أن العلم ليس مجرد جوهر بل مظهر لتقدم العلم.
يذهب أيضًا “ابن خلدون” إلى أن التاريخ يدور حول نفسه، وأن الدول التي تتداول الحكم ولا تتعدى في حكم كل منها عمر الإنسان، تنطلق الواحدة منها من الأساس الذي انطلقت منه الدولة السابقة، أي أن الدولة الظاهرة تقضي على الدولة المنهزمة وتبدد معالمها، وبالتالي تصبح مرغمة على إعادة البناء من جديد.
إن التاريخ يدور في حلقات متعاقبة يسير إلى الأمام، وعلى هذا الأساس يعد التاريخ تواصلًا وتكاملًا بين الماضي والحاضر، وتشكل الأعمال السابقة والأصول التي تقام عليها وتنطلق منها الأعمال الحاضرة.
في جدل التراث
بعض التيارات لا تدعو للقطيعة، فمنهم من يدعو إلى تمجيد الماضي وإضفاء طابع القداسة على النصوص والشخصيات، مستعينًا بإنجاز الماضي المقدس هروبًا من الواقع المدنس، والتمثل بالتراث وطلب الغوث منه فهو منقذنا مما نحن.
تيار آخر يتجه إلى الدفاع بالتاريخ العربي وإنجازاته العلمية ومدى تأثيرهم العميق في نشوء الحضارة الغربية، من دون أن يستخلص هذا التيار الدرس والبحث عن ما هو جديد، وكانت معظم كتاباتهم تدعو إلى الحنين إلى الماضي والسلف، وفق مقولة “ما ترك الأولون للآخرين من شيء”.
كما نجد تيارًا يدعو إلى دراسة التراث دراسة إبستمولوجية علمية نقدية، ليس من أجل ذكر الماضي فهو درس للتاريخ، وإنما وفق تتبع خطى الغربي الذي أحدث قطاعًا متعددة في تاريخه، إلى أن وصل به الأمر إلى التكنولوجيا والعولمة والحداثة وما بعد الحداثة.
مفهوم القطيعة الإبستمولوجية مع التراث
إن المعرفة العلمية مهما وصلت إلى درجة التجريد والتعميم فهي استمرار وتطور للمعرفة العامة، والاستمرارية تدعو دائمًا إلى العودة بالعلم إلى أصول قديمة، وهم يرون أن العلم الحاضر جاء من تلك الأصول القديمة بصورة بطيئة، والأخذ منها ما هو مشترك إنساني مثل علوم التكنولوجيا والعلوم التقنية والطبية، وتجنب التأثير على الخصوصيات الحضارية والهوية الخاصة بمجتمعاتنا، وهذا نتيجة الخلل الكبير في الفكر الغربي المادي على مستوى المعرفة الواقعية كما ذكرنا سابقًا، فإن كان متقدمًا علميًا إلا أنه بكل تأكيد متخلف أخلاقيًا وإنسانيًا وقيميًا، وهذا في غاية الوضوح بالنظر إلى ممارسات تلك الشعوب مع باقي شعوب العالم، من نهب ثروات وسيطرة على العقول والموارد والتحريض على الحروب.
لا توجد بين الماضي والحاضر قطيعة إبستمولوجية لأننا نعيش بلا ماضي، فهذا مستحيل من الناحية الثقافية والعقلية، وكل الاتجاهات التي رأت أن هناك قطيعة هي اتجاهات تغريبية، تتعامل مع التراث كأنه حقبة تاريخية وانتهى أمره، بينما التراث متجدد وما زال يعيش عبر الثقافة والحياة اليومية، والفكر إن لم يكن من باب الحلول فمن باب الإشكاليات، وهذا ما قاله “حنفي” في التراث والتجديد وما قاله “عابد الجابري” في كتابه نحن والتراث. فما أحوجنا إلى فكر اعترافي تسامحي يدعو إلى الحوار دون تهميش لأي طرف أو مجال أو أقلية.
مقالات ذات صلة:
المعرفة الحدسية المباشرة: نفسيًا وفسيولوجيًا
نظريات علم الاجتماع على ميزان العقل
كثير من المعرفة وقليل من الفهم
* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
*********
لمتابعة قناة اليوتيوب لأكاديمية بالعقل نبدأ، اضغط هنا
لقراءة المزيد من المقالات، اضغط هنا