حوار مع الباحث رأفت محمد مؤلف كتاب “قبل الانهيار” – عن العلاج المعرفي للأزمات النفسية والأخلاقية
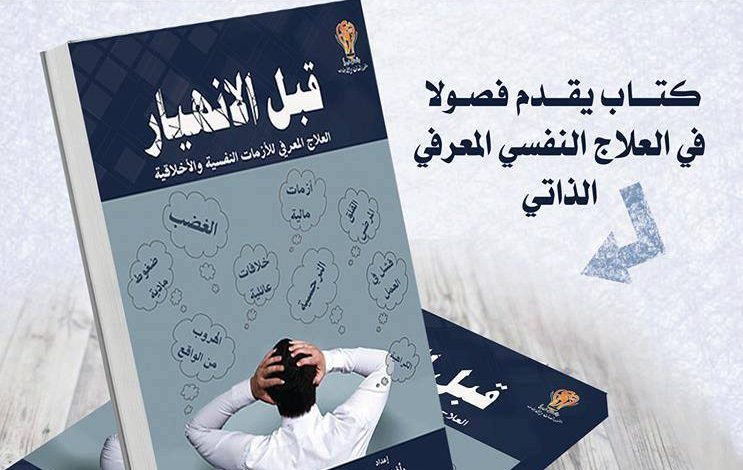
حوار مع الأستاذ رأفت محمد
الباحث في علوم التنمية الاجتماعية والسلوكية بمركز “بالعقل نبدأ” للتنمية الفكرية والمهارية
والحاصل على دبلومة تنمية المجتمع من كلية الآداب جامعة عين شمس
وصاحب كتاب “قبل الانهيار: العلاج المعرفي للأزمات النفسية والأخلاقية”
في استقصاء أجريناه، وجدنا أن فقدان الهدف وانعدام الضمير في مصاف المشكلات التي نعاني منها بشكل جماعي. كيف ترى تلك المشكلات؟
يقول بعض علماء النفس ويوافقهم كثير من علماء الاجتماع بأن الأخلاق “مُعدية”، سواء كانت حسنة أو سيئة. وهذا قد يكون صحيحًا إلى حد كبير ذلك بالنظر إلى النخب الموجودة في كل مجتمع والتي تتوسط التقسيم الهرمي بين السلطة والشعب، هذه النخب ينبغي أن تتحلى بالقدر الكافي من المميزات العقلانية والملكات الأخلاقية طالما أن مهمتهم إرشاد الناس، بل من الواجب أن يتمتعوا ويتقنوا سبل التفكير المنطقي السليم، الذي يكون المحرك لهم لتهذيب أنفسهم وتخليصها من الآفات الظاهرة مثل الغش والكذب والنفاق الذي يجعلهم يقلبون الحقائق ويزيفون الوعي من أجل مكاسبهم الشخصية.
ما هي تلك النماذج “أو النخب” التي تصفونها بالغياب؟
في البداية رب الأسرة، المعلم، رجل الدين، ويأتي بالتبعية الإعلاميون والفنانون والساسة والمفكرون.
الأسرة، التي هي بناء المجتمع الأساسي، فبعدما كانت قيم التواصل العائلي هدفها نقل الخبرات بالمعايشة والقدوة وسماع تفاصيل حياة كل فرد، تم استبدال هذا التواصل الجوهري لاستمرار الأسرة إلى وسائل بديلة، تحل محل التواصل بين الأسرة، وذلك على محاور عدة، فالإعلام مثلا يقدم دعاية مجانية لمجموعة من القيم هي في أغلب الأحيان مغايرة لقيم وأخلاقيات المجتمع، فحل التسيب محل الانضباط، سواء السلوكي أو الحواري. ولأسباب متباينة انشغل رب الأسرة بلقمة العيش فبات كأنه ميكنة تدر أموالا فحسب.
وما ينطبق على الأسرة يسري أيضا على دور المعلم ورجل الدين، ففي السابق كان الاحترام لكل من رب الأسرة والمعلم ورجل الدين وكبار السن عموما من ثوابتنا القيمية والأخلاقية، ومع غياب الاهتمام بالمعلمين من النواحي المادية والمعنوية والمهارية، صار المعلم في ذهنية الطلاب “حصالة” تجمع المال بشتي الطرق.
ما السبب في الحالة العامة من غياب القدوة؟
أرى أن الفن والإعلام يحملان مسؤولية كبرى سواء في تضخيم المشكلة، والتقصير في الحلول، ودعني أشرح لك… كيف نفسر موقف شاب من سيدة فى مواصلات قام وأجلسها مكانه، وسائق «ميكروباص» لا يتفوه بالألفاظ السيئة؟ وبنت تحافظ على الآدب العامة للبنات وطالب مجتهد يحضر دورسه ويثقف نفسه؟! هذه نماذج موجودة أيضا فى مجتمعاتنا وإن كانت قليلة إلا أنها موجودة، فمازلنا نرى أخلاق «ولاد البلد والرحمة بالكبير ومساعدة المحتاج». مجتمعنا ليس كله بلطجة وسارقين ومرتشين ومنعدمي أخلاق، فبيننا المثقف والمجتهد والباحث عن الحق والذي يريد أن يساعد ويكون له دور.
لكن للأسف فالإعلام والفن باتا مقتصرين على تقديم الصور السلبية للمعلم المهمل، ورب الأسرة الهارب من مسؤولياته والباحث عن نذواته، ورجل الدين النصاب، أو صاحب العقلية المنغلقة، والسياسي الانتهازي، والأديب الفاشل والمفكر المجنون!
لكن الإعلام والفن “مرآة المجتمع” ودورهما هو رصد السلبيات وهو أمر صحي، أليس كذلك؟
هذا صحيح، ولكن لماذا لا نُظهر إيجابيات المجتمع حتى نعطي الأمل أن الخير موجود، وكذلك هل السلبيات التى يُظهرها لنا الإعلام هي بهذا السوء فى الواقع فعلا؟ هل كل غني لا بد أن يكون قاتلا ويعطي الرشاوي ويخطف وو… ، هل كل بلطجي يظهر فى فيلم أو مسلسل هو راضٍ عن وضعه الحالي ولا يسعى لأن يكون أفضل؟
أسئلة كثيرة لابد لكي نساعد أنفسنا ومجتمعنا أن نجيب عنها بوضوح وشفافية، وإن كنا عاجزين عن توصيل أصواتنا فلنا الحق بل يجب أن يكون لنا الحق في رفض هذا التعميم الذي يظهر الجانب السيئ فقط ليعطي انطباعًا عامًا بأننا أسوأ الشعوب، وأنه لا مجال للإصلاح والرقي. كذلك وعلى النقيض مما يظهر عن مجتمعنا بأن المجتمعات والشعوب الأخرى أكثر تحضرا ورقيا بمراحل عمَّا نحن فيه.
إذن ما هو الدور الأمثل للفن والإعلام في رأيكم لحل مشكلات القدوة وغياب الضمير والقيم؟
تابعت منذ فترة وجيزة نفيا قاطعا من صفحة “اليابان بالعربي” للعديد من الإشاعات التي تخص مظاهر الحياة في داخل اليابان، حتى إن البعض أسماها “كوكب اليابان” من كثرة ما قيل من معلومات تخص مظاهر التقدم والرقي في اليابان، اتضح بعد ذلك أنها مبالغات.
أعيد وأكرر: هل ما يبث لنا من صورة مثالية عن الشعوب تجسد صور الرحمة بالحيوان مثلا والرقي فى التعامل مع الناس بعضها البعض وعن حقوق الإنسان والانتظام فى وسائل المواصلات واحترام القانون هي صورة حقيقية عن تلك الشعوب؟ أو بالأحرى هل هي صورة عامة لجميع أفراد المجتمع؟ لا ينكر أى عاقل وجود السلبيات والإيجابيات فى أي مجتمع ولكن تعظيم الإيجابي ونقد السلبى من أهم خطوات تقدم الشعوب، أما عرض السلبيات بتلك الصورة الفجة وغياب أو تغييب الإيجابيات وإن كانت قليلة لهو عامل يساعد على الإحباط وفقد الثقة بالنفس ويكرس من «عقدة تفوق الخواجة» ويفقدنا القدرة على التقدم والرقي الأخلاقي والثقافي والعلمي اعتمادا على أنفسنا.
إن أفضل طريقة يقوم بها الإعلام للدفاع عن القيم والإيجابيات هى ممارستها وتشجيع الناس على الاستمرار فى تبنيها وعدم التقليل والتسفيه من أصحاب القيم، لأنهم ببساطة هم النور الباقي وسط هذه العتمة الهائلة والتي يجب أن نعظمها حتى تمتلأ مجتمعاتنا بنور العلم والأخلاق. وهذا لايعني تهميش السلبيات وغض الطرف عنها، بل يجب أن نقدمها مع عرض الحلول لها والتنويه على النماذج المضيئة حتى لايفقد الناس الأمل في التطوير والتغير.
كلمة أخيرة توجهها لكل شاب يعاني من أزمة غياب الهدف، والتشاؤم
الاثنان مرتبطان ببعضهما، وأضف إليهما الاكتئاب ومشكلات القلق، إن الحل يبدأ أولا بكشف الهدف الحقيقي من العيش على تلك الحياة، وهذا البحث ليس قاصرا على المفكرين والفلاسفة، أو يعتبر دربا من الرفاهية، بل على العكس فإن الحل يكمن في اتخاذ مبادئ صلبة يحيا عليها كل إنسان، ويعيش من أجلها وفي خدمتها، وإلا تصبح حياتنا عبثية وفوضوية، أو فارغة بلا أي مضمون.
وعلى هذا الأساس “بالعقل نبدأ” ! لأن تعلم التفكير المنطقي هو الوسيلة المثلى والأولية للوصول للمبادئ عن الكون والحياة، وحقيقة الإنسان وغاية وجوده، وإذا أدركنا ذلك، لتحولت حياتنا من الفراغ إلى القيمة، ومن العبث إلى المعنى، وهو مايسهم بشكل جذري في الوقاية من مشكلات عديدة أهمها التشاؤم، والشعور بفقدان المعنى والهدف.

