لماذا أشغل نفسي بمعرفة أصل القانون، أنا لا أريد أن أعرف!
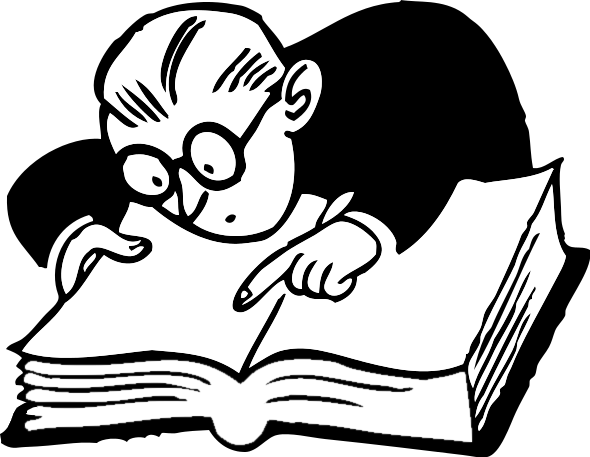
كنت مع صديقي، نذاكر مادة تتطلب الكثير من الفهم والتمرين، الحق إنها لم تكن مادة سلسة التناول مع كونها مثيرة وممتعة من ناحية الموضوع والنواتج. كنت أحب دائما أن أفترض أن ما أقرؤه يحتوي خطًا، وأن من قام بشرحه… حسنا، فلنقل إنه لا يعرف ما يتحدث عنه، وللأسف -أو ربما لحسن الحظ – كانت بعض التجارب تؤكد صحة هذا الافتراض.
– “هذا الحل يبدو لي خاطئا… هناك قفزة منطقية ما… من أين أتى هذا السطر؟ فلنحاول إعادة استنتاج القانون.”
رد صديقي في نفاذ صبر
* “لا أعرف من أين أتى، وحقيقة لا أريد أن أعرف!”
كنا نعرف جيدًا ما معنى أن يستنتج طالب في وضعنا قانونا، ما معنى أن يرهق نفسه في تفاصيل إضافية، مع كون المنهج طويلا وصعبًا بما يكفي، والوقت مضغوطا نتيجة لوجود مهام ومواد أخرى. هكذا أصبحت الدراسة في وقتنا الحاضر في العديد من التخصصات: مجرّد حشو للذاكرة بمجموعة من المعلومات المتناثرة، وترتيبها في الذهن والتمرن على استدعائها وسكبها عند الطلب وبالسرعة المطلوبة وذلك بمجرد سماع الكلمة المفتاحية. لم يكن يوجد شخص طبيعي يحب أن يذهب إلى الأستاذ الجامعي الذي يدرس المادة ليسأله في موضوع قريب من نطاق المنهج. امتحانات السنين السابقة موجودة وحلولها متوافرة، وقد يعجب الأستاذ بالسؤال لا قدّر الله ويطلب من الدفعة إعداد بحث فيه، أو يشرح جزءا إضافيا بخصوصه ويؤكد أن الامتحان لا بد بأن يتضمن سؤالا عن هذا الجزء.
لم يكن أوائل الدفعة، أولئك الطلاب الذين يبدو أنهم لا يفعلون شيئا سوى المذاكرة والبحث، ولديهم قدرة لا نهائية على تحمّل الرتابة والملل والجلوس لفترات طويلة، هؤلاء النخبة لم يكونوا على دراية بالمشاكل التي تواجه “رجل الشارع البسيط”، وكانوا يخرقون قانون السكوت عما يشوبه عدم الوضوح بأسئلتهم الفضولية، التي أحيانا ما تنجح في إثارة انتباه المحاضر وتحمّسه، وتنتهي بالنهاية التي ذكرناها سابقا. لم يكونوا حقيقة يفهمون سبب تلك النظرات التي يرونها على وجوه طلاب الدفعة بعد المحاضرة، نظرات تعبّر عن مزيج من الضجر والحسرة والغضب.
“لا أريد أن أعرف” صارت سمة العصر، ما لم يكن يترتب على هذه المعرفة “مصلحة” ما: ميزة تنافسية في سوق العمل أو تطبيق مباشر نافع مثلا. لا عجب إذن أن تتسم الثقافة السائدة بالسطحية والانتهازية حيث القليل هم من يبحثون عن العلم للعلم والفهم الشامل والأغلبية تنتهج الفهلوة والبحث عن أكبر مردود بأقل قدر من التعب، عما خف وزنه وارتفع ثمنه. الشيء المتفهم هو الإنسان نفعيّ في بحثه عن العلم، وهكذا يجب أن يكون، يتعلم ليفعل شيئًا، لا ليطرب عقله بتناول الجديد وفهم المتقدم[i] وحسب. فكما قال المفكر الراحل محمد إقبال: ليس منتهى غاية الذات أن ترى شيئًا بل أن تصير شيئًا. الأفضل إذن والأدق أن نقول إنّ الإنسان هادف أو غائيّ في تعلّمه.
كم منا ينهي تعليمه في مراحل الدراسة الرسمية فقط ليتفاجأ بأنه في الحقيقة لم يتعلم العديد من الأشياء الضرورية؟ يجد نفسه مضطرا لإعادة دراسة اللغات الأجنبية مثلا بشكل يفيده عمليا أو حتى المواد التخصصية التي درسها، ينظر إليها كما لو كانت علما حقيقيا سيطبقه وليست قطعا من “المحفوظات”، ويتكلف جهدا ووقتا وفي كثير من الأحيان مالا أيضا في سبيل ذلك.
في كثير من الأحيان نقع في مشاكل نقف أمامها عاجزين رغم ما لدينا من تعليم واطّلاع، نجد أننا مع كثرة ما مر بنا من المعلومات ليس لدينا “علم” يُعتمد عليه في تحقيق نتائج صلبة، ملموسة. نحن في الواقع نريد أن نعلم، ونحب أن نشعر الأمور التي ليس لدينا علم بخصوصها يتولاها من لديه هذا العلم. حتى هذا القانون الذي كنت أودّ إعادة استنتاجه مع صديقي: هو فقط أراد يبني انطلاقا من ثقته في علم من استخدمه.
يجب أن نعرف، ونعلم! وبينما هو من المحال معرفة الفرد كل شيء فهذا يعني إنه يجب على عدد كافٍ من الأكفاء أن يغطوا كافة التخصصات المختلفة، وأن يوكل أمر ما تخصصوا فيه إليهم. فبهذا نأمن أن الأمور تدار بعلم، وبهذا ننعم بالعدالة والرخاء، وبهذا لا تضيع مجهوداتنا ومواردنا بلا طائل. وبهذا نكون أرقى وأكمل.
حتى هذا يعتبر هدفا وإن كان غير ذي أثر مادي محسوس
لقراءة المزيد من المقالات يرجى زيارة هذا الرابط
ندعوكم لزيارة قناة الأكاديمية على اليوتيوب
