باريس في الأدب العربي الحديث
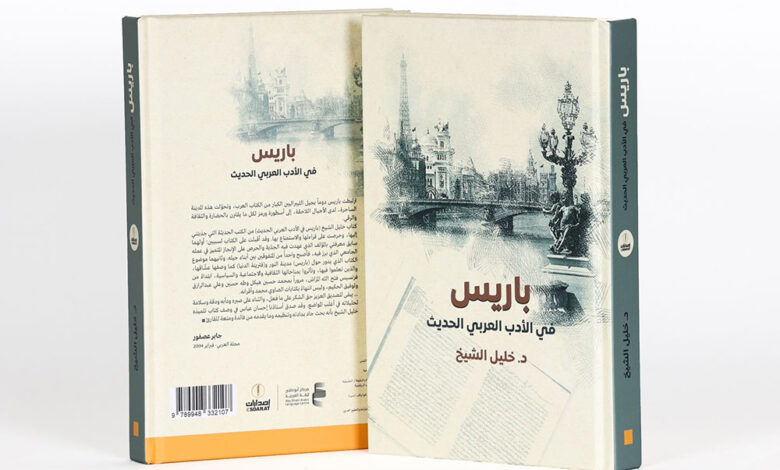
أهداني الناقد الكبير والأستاذ الجامعي البارز د.خليل الشيخ كتابه المهم “باريس في الأدب العربي الحديث” حينما كنت منشغلًا بإعداد دراسة حول طه حسين، فبرقت في رأسي فكرة عن دور هذه المدينة في تصور عميد الأدب العربي للعلاقة بين الشرق والغرب، وكذلك من سبقوه إليها، ومن لحقوا به.
باريس لم تكن بالنسبة إلى طه حسين مكان سياحة، حتى لو ساعده غيره في وصف شيء من تفاصيله، لتصل إليه بعض لذة المبصرين، إنما كانت حلمًا ومعنى، ومركز اختبار لعلاقة الشرق بالغرب في لحظة تاريخية مغايرة، إذ جاءت في أيام كانت تتضارب فيه هذه العلاقة بين صراع وتكامل، وإقبال وإحجام، وتكيف وانعزال، وتحدٍ وتمثل، وإعجاب ومقت، وكل مشاعر التقلب ومواقفه التي يمكن أن تنشأ وتسري بين غالب ومغلوب، تبادلا المواقع والمواضع الحضارية عبر قرون ممتدة.
لم يكن طه حسين مشغولًا بالنزهة، فوقت ذهابه إلى باريس كان أهل فرنسا أنفسهم يقولون “نتمنى أن تكون باريس نظيفة مثل القاهرة”، إذ كانت شوارع الأخيرة، في الأحياء التي بناها الخديوي إسماعيل على غرار عاصمة فرنسا، تُغسل كل صباح بالماء والصابون، أما في غيرها من الأحياء الفقيرة فقد كانت هناك زمتة وهواء فاسد وروائح مختلطة بعضها كريه، وصفه طه نفسه في كتاب “الأيام” وصفًا دقيقًا مفصلًا.
كانت باريس بالنسبة إليه “نقطة الانطلاق نحو المشروع الحضاري”، وهو في هذا يتفق مع كثير من سابقيه، في المقاصد والغايات، حتى لو تفاوتت صيغ التعبير أو اختلفت عنها، فرفاعة رافع الطهطاوي كانت هذه المدينة بالنسبة إليه “منبع العلوم والفنون والصنائع”، وعند علي مبارك “رمز التقدم المادي”، وعند فارس الشدياق كانت “جنة النساء ومعدن العلوم واللذات”، وفي رأي فرانسيس مراش “الجنة ومكان تحقيق الذات”، وعند أحمد شوقي كانت “مدينة النور والقِبلة الحضارية”، واعتبرها الشيخ مصطفى عبد الرازق عاصمة الدنيا، و”الجنة التي تجب محاكاتها”، وتعامل معها محمود تيمور على أنها “منبع التجديد الفني”.
وقد انتقلت باريس لدى عميد الأدب العربي من ثالوث “العلم والفلسفة والحرية” حين وطأها أول مرة ساعيًا وراء العلم، إلى ثالوث “العقل والقلب والذوق” حين أتى إليها بعد عشرين سنة ساعيًا وراء نزهة لا تخلو من معرفة وتعارف، بعد أن صار هو في أثناء هذين العقدين مُمكَّنا في قومه، وملء السمع والبصر في ثقافته، ومن الأعلى صوتًا والأعمق تأثيرًا من بين الكتاب والمفكرين في أهل لسانه.
بمرور الوقت وطد طه حسين علاقته بباريس، وحاول اكتشاف مختلف أبعادها الحضارية والجمالية، فظلت بالنسبة إليه المدينة “الأكمل والأجمل”، وبقيت زيارته لها سنويًا برفقة أسرته أشبه بواجب مقدس، وهو أمر تعاونت عليه العاطفة والعقل، ففيها، وبعد شهور من العزلة القاسية التي لازمه خلالها أبو العلاء المعري بتشاؤمه الصارم، جاء الفرح والانفتاح والبراح على يد صاحبة الصوت الساحر، التي صارت حبيبته فخطيبته ثم زوجته حتى نهاية عمره. وفيها جاء تعميق دروس التاريخ والحضارة والأدب والقانون، التي بدأها قديمة تقليدية في الأزهر وعصرية نسبية في الجامعة الأهلية.
هذان الأمران المرتبطان بعاصمة فرنسا: الفكر والمشاعر، ربما رسما ملامح رؤية طه حسين للعلاقة بين الشرق والغرب، لا سيما أن باريس، في هيئتها العصرية التي كانت عليها، مثلت وقتها ذروة العطاء الحضاري المبتغى، مثلما كانت كذلك بغداد ودمشق أيام ازدهار الحضارة الإسلامية، حسبما يعرف طه في دراساته الأدبية والتاريخية والدينية.
لعل كتاب “صوت باريس” يعكس هذا التصور، ففيه أبدى طه حسين منهجه في النقد الأدبي والفني، جنبًا إلى جنب مع محاولة إفادة الكاتب والناقد والقارئ العربي، في ذلك الزمن المبكر، مما وصل إليه الأدب والفن في الغرب، عبر استعراض وتحليل ثلاث وعشرين قصة تمثيلية لأدباء من فرنسا والولايات المتحدة والمجر، مُثِلت على مسارح باريس. وهذا المذهب النقدي تعاون على صناعته الفكر الغربي والشرقي معًا، وتلك القصص الغربية كان أهل الشرق في حاجة إلى أن يطلعوا عليها.
ينقل عميد الأدب العربي هذه النصوص لنا، ليس بترجمة مباشرة لها عن لغاتها الأصلية، لكنه يحكيها هو بطريقته، بعد أن أنصت إليها، ووعاها، وأدرك مراميها، فوضعنا أمام الحدث الفني للقصة، وربطها بسياقها، وأدلى برأيه فيها، ويتتبع تأثيرها. ورغم أنها صارت الآن من كلاسيكيات الأدب الأوروبي، فهي دالة في البرهنة على الدور الذي لعبته باريس في تشكيل وعي الشرقي طه حسين بالغرب، ورغبته في أن ينهل منه على قدر استطاعته، وينقل هذا طيعًا عفيًا إلى بلاده.
إن باريس على هذا النحو، صارت مكان الحوار الذي أقامه طه حسين بين حضارتين ومجتمعين وتاريخين إنسانيين، وهو قد وجدها المكان الأمثل لهذا الإجراء المهم، وهذه الموازنة والمواءمة التي كانت ضرورة أيامها، وربما تظل إلى الآن، فهي في نظره عاصمة العالم الحديث ومختصره، وهو قادم من أهم عواصم الشرق في ذلك الزمن، وهو نفسه كان الشخص المؤهل لإجراء مثل ذلك الحوار، فيما يتأمله ويُنقل عنه، إذ إنه قادم من مجال تعليم ديني تقليدي قوامه الموروث وآخر مدني يتشكل على مهل، إلى آخر عصري ينطلق بقوة نحو المستقبل.
وهذا المسار الحواري استمر بعد طه حسين، إذ رأينا توفيق الحكيم يرى باريس مدرسة عظيمة لتعلم المسرح، ويراها زكي مبارك مكانًا مناسبًا للتعلم وتحقيق الذات، ويتعامل معها أحمد الصاوي محمد على أنها “بؤرة العالم”، لكنها لا تلبث أن تنتقل من المقدس إلى المدنس في شعر عبد الوهاب البياتي، وتصير أيضًا “مدينة بلا قلب” كالقاهرة في شعر أحمد عبد المعطي حجازي، وينتقل دورها من الحوار إلى الاستكبار في رؤى مالك بن نبي، ليصالحها أدونيس، ويتكيف معها، ويراها من جديد مركز الحضارة الغربية.
اقرأ أيضاً:
هومي بابا والقراءة النفسية بين الأنا والآخر
حاجتنا إلى النقد الأدبي الخلَّاق
* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
_________________________________
لمتابعة قناة اليوتيوب لأكاديمية بالعقل نبدأ، اضغط هنا
لقراءة المزيد من المقالات، اضغط هنا
