التفلسف عربيًا أو في إمكان ولادة الفيلسوف العربي
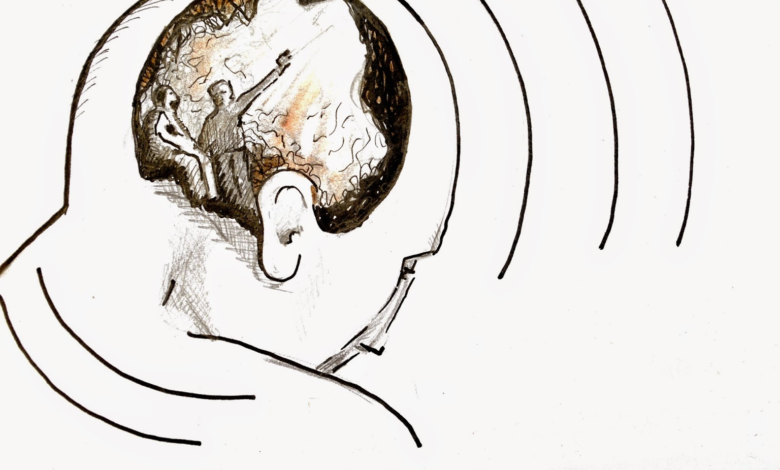
هل ثمة فعل تفلسفي عربي جديد على المستوى الجمعي من جهة؟ وهل ثمة إمكان، من جهة ثانية، لولادة فيلسوف عربي على المستوى الفردي؟
يُمكن اقتراح إجابة عن هذا السؤال المزدوج من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول
اعتبار السؤال السابق سؤالًا استنكاريًا، لناحية انتفاء وجود فيلسوف عربي على المستوى الفردي، أو فعل تفلسفي عربي على المستوى الجمعي. ومع هذا الوجه يُمكن أن يتخلق سياق إنكاري يُؤشِّر على حالة الهوان المعرفي التي وصلنا إليها، إذ أخرجنا فعل التفلسف من أُطره الطبيعية التي يفترض بالإنسان السوي عقليًا أن يمارسها بشكل عفوي، إلى أن يُعمِّق مراناته وتدريباته المعرفية، فتُصبح ممارستها عملية واعية تمامًا، فأصبح فعلًا طارئًا، أي فعل التفلسف، فالسوية العقلية بالتالي حدث طارئ هي الأخرى!
يمكن لحالة الإنكار هذه أن تتعمق أكثر في ظلِّ نسقين ضاغطين: الأول ماضوي متعلق بفلاسفة كبار أنتجتهم الحضارة العربية في عصور قديمة، وتأثيرهم الواضح إبَّان العصور الذهبية للحضارة العربية، والثاني غيري متعلق بفلاسفة كبار أنتجتهم الحضارة الغربية وتأثيرهم الواضح في النهضة الغربية الحديثة.
ففي ظل هذين النسقين، يمكن تحطيم ثقة المُتفلسف العربي الحديث بنفسه، فينظر بعين كليلةٍ ومريضةٍ إلى ما يُنتجه من معارف، إذ يرى فيها، على الدوام، دونية تحط من قدرها، فيجعلها أقل جودة ومستوى مما أُنتج من أسلافه أو من الآخرين، فيركن مع الزمن إلى الخنوع والاستسلام، فيصاب بعجز معرفي دائم، سينعكس سلبًا على مُجمل الأمة ووضعها الحضاري.
الوجه الثاني
بصفته سؤالًا استفهاميًا، وفي إطار البحث عن إجابة شخصية عن هذا السؤال في هذا المقام، فقد تحدثتُ في كتابي “الإنسان الفيلسوف: عن أسئلة الأطفال وإجابات الحكماء”[1]، تحديدًا في الفصل الثاني منه، عن عدد من النماذج المُبدعة التي استطاعت التفلسف بالمادة التي تشتغل، نتيجة لتوافرها على جُملة من الاشتراطات، منها:
- الثقة النفسية التي تُعزّز مركزية الذَّات، بما يتجاوز محنتي الأسلاف والأغيار التي أشرتُ إليها آنفًا.
- البناء المعرفي المتين، أو إتقان المجال الذي يتحرَّك فيه المُبدع، من قراءته واستيعابه وهضمه ومن ثمَّ تجاوزه.
- الإمكان الإبداعي، الذي سيدفع بفكرة تجاوز المعارف السابقة ناحية الأمام، أما إذا لم يتوافر هذا الشرط، فسيبقى المشتغل تابعًا لا مُبدعًا، وسيصاب بعسر شديد لحظة تجاوز معارف الآخرين.
فنجيب محفوظ في الرواية، مثلًا، ونصير شما في الموسيقى، مثال آخر، وفن الآرابيسك المصري في صناعة الخشب، مثال ثالث، وفيروز في الغناء، مثال رابع، إلخ، من الإمكانات المشرقة التي تُنبئ بحالةٍ من الإتقان الشديد للعمل المُناط إنجازه ويُفضي إلى القيم الإنسانية الكبرى.
أما عن الاستفهام حول وجود فيلسوف عربي على المستوى الفردي، فيمكن التأشير على أن السياق الضاغط لحظة إطلاق لقب على أحد ما بأنه فيلسوف هو سياق عاطفي أكثر منه سياقًا معرفيًا، أو بالأحرى سياق هُويَّاتي أكثر منه سياقًا معرفيًا. فكثيرون من أتباع الدكتور “طه عبد الرحمن”، مثلًا، يُطلقون عليه لقب فيلسوف بصفته مُنافحًا كبيرًا عن السياقات الكبرى للدين الإسلامي، أو بالأحرى عن السياقات الهَوَويَّة للأمة الإسلامية، فهو لم يصطلح على افتهامات جديدة لثُلاثية: الإله والإنسان والعالَم، ويُقدمها في إطار معرفي يهدم فيه أبنية قائمة ويُقيم أبنية جديدة، بل بقي حديثه يدور في الفلك الهووي للكينونة القائمة، فأتى لقب فيلسوف منسجم مع هذه الروح الهُويّاتية القارة، وفي أعنف الحالات يمكن تصنيفه لاهوتيًا! إن جاز التعبير على حالته.
الفرق بين اللاهوتي والفيلسوف فرق كبير، فالأول يُوشكُ أن يتفلسف لكنه خوَّاف، لكن الثاني لا يتجاوز الخوف فقط، بل والموضوعة اللاهوتية برمتها، أو على الأقل يُعيد تقعيدها من جديد نظرًا لعدم صلاحية التقعيد القديم لها لمواضعات الاجتماع السياسي الجديدة، لكن ما يفعله “طه عبد الرحمن” إعادة صياغة للقديم بلغة منطقية حديثة، ليس إلا.
الوجه الثالث
في الاستقصاء عن السؤال المزدوج أعلاه يُمكنني التأشير على أنَّ واحدة من استحقاقات ما اصطلح عليه بـ”عصر النهضة” العربي، من بدايات القرن التاسع عشر وحتى اللحظة، تفعيل الحراك العقلي تجاه كثير من الثوابت التي احْتكَمَ إليها الإنسان العربي وحكمته لأزمانٍ طويلةٍ.
أي طُرحَت جُملة من الأسئلة في وجه إجابات قاطعة ونهائية، بعد أن كانت تلك الإجابات قد قرَّت وثبتت لأزمان طويلة في أذهان الناس ومسلكياتهم الحياتية، فصارت جزءًا لا يتجزأ من هُويّة الأمة وكينونتها، لذا دوفِع عنها –أعني الإجابات القاطعة والنهائية– ببسالةٍ وشراسة، بصرف النظر عن مدى صحتها من فسادها، وما زال الدفاع عنها بعنفٍ بالغ قائمًا حتى اللحظة، فأي سؤال يُطرح يُصَنَّف كونه سؤالًا طارئًا ويُشكّل تهديدًا واضحًا ضد روح الأمة وهويتها العميقة، مع ما يستلزمه هذا التصنيف من عقابٍ، تتفاوت حدته، لصاحب السؤال أو لمن يتبنون هذا السؤال.
بتبصّر ليس لطبيعة تلك الأسئلة، التي كان أبرزها سؤال: لماذا تأخرنا وتقدّم الآخرون؟ بل لتفاعلاتها في الاجتماع السياسي، سنجد أنها تعالقت بشكلٍ أساسي مع النصّ الديني ومُلحقاته، بصفته الفاعل الأكبر في صياغة عقول الناس ووجدانهم، وانعكاسات تلك الصياغات على آليات تصريفهم لمعيشهم اليومي وتعالقات المعيش الدنيوي مع المآل الأخروي.
الدِّين كان قد حلَّ في صُغريات الأمور وكُبرياتها، وتدخّل في تصريف شؤون الإنسان العربي لطرق معيشه، ابتداءً من دخوله دورة المياه وليس انتهاء بتفكيره بالمُقدَّس، لذا كان من الطبيعي أن تتعالق الأسئلة المطروحة على النص الديني ومُلحقاته التي حفَّت به في فترة من الفترات، ثم أصبحت جزءًا أصيلًا من ماهيته مع الزَّمن. وعليه، فقد تنامى التعالق بين الأسئلة والمكوّن الديني ومعه تنامى الجدل، ووصل إلى مراحل متطورة في العصر الحديث.
بالعودة خطوة إلى الخلف، تحديدًا إلى الفترة الأندلسية التي شكلّت ذروة من الذروات المعرفية في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية تحديدًا، والثقافة الإنسانية عمومًا، كان الاشتباك المعرفي الأكبر مع النصّ الديني على نحو مخصوص. فالدِّين، في الثقافة العربية الإسلامية، معمار هائل سكن فيه الجميع، من فلاسفتهم إلى شيوخهم.
إذا أخذنا حالة ابن طفيل، مثالًا، في قصة “حي بن يقظان”، وحالة ابن رشد، مثالًا ثانيًا، في كتاب “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، سيظهر لنا ذلك بشكل جلي. فـ”حي بن يقظان” تجاوز الصيغ التقليدية للتدين، لكنه لم يتجاوز الروح الكُليّة للدِّين أو نواظمه الكبرى التي حدّدت مُنطلقاته المبدئية ومآلاته الأخروية. وفي المثال الثاني حاول “ابن رشد” في “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال”، أن يُجسّر الهوّة بين العقل والنقل، دونما إخلال بأي طرف على حساب الآخر.
لقد شكّل النص الديني وتابعاته من نصوص شارحة وموضّحة، الهاجس الأكبر بالنسبة إلى الإنسان العربي، ليس على المستوى العقلي فقط، بل والوجداني أيضًا. مما جعله، أي الدِّين، يلتحم بشكلٍ لصيق بالاجتماع، لذا صار تفكيك الاجتماع يتطلب حفرًا عميقًا ومبدئيًا في النصّ الديني.
هذا ما انعكس أيضًا على الأسئلة التي اضطلع بها “عصر النهضة”، إذ شكّل النصّ الديني –بصفته حاملًا للاجتماع الإنساني ومحمولًا عليه– المُنطلق، في الغالب، لتلك المقاربات المعرفيـة التي تجلّت في متونها اقتراحات للإجابة عن أسئلة المشروع النهضوي العربي.
مثل رؤى رفاعة الطهطاوي ومشروع جمال الدين الأفغاني واجتهادات الإمام محمد عبده وكتابات مصطفى صادق الرافعي وعبد الرحمن الكواكبي وشبلي شميل وطه حسين، إلى آخر هذه السلسلة الفاعلة والنشيطة، إذ كان الحضور الأبرز في النشاط المعرفي العربي لما يقارب القرنين للنصّ الديني ومُلحقاته، إذ استحوذت النقاشات والسجالات حوله، منذ ذلك الحين وحتى اللحظة، على نصيب الأسد من مجمل النقاشات التي جرت في العالم العربي، فالمعارك المعرفية الكبرى حدثت حول الدين أو حول تجلياته في الاجتماع السياسي، وما زالت تحدث حتى اللحظة.
في تداعيات هذه السجالات حدثت مطاحنات كثيرة بين عقول شتّى، كانت في بداياتها مطاحنات فردية، وبقيت وتيرتها تتصاعد ببطءٍ شديد على المستوى الفردي، إلى أن انفجرت أحداث ما اصْطُلِحَ عليه بـ”الربيع العربي”، فمعها احتدمت حدّة النقاشات وأخذت تنتشر بوتيرة سريعة، وقد ساعد على ذلك الانتشار الكاسح العوالِم الافتراضية، إذ تحوّلت المنصات الإلكترونية بأشكالها المختلفة إلى فضاءات للنقاش والجدال والحوار حول اهتمامات المجتمعات العربية.
بطبيعة الحال فقد حظي الدين ومُلحقاته بنصيبٍ وافر من هذه النقاشات، التي لم تعد حكرًا على المفكرين والبحّاثة فقط، بل انخرطت أجيال في هذه النقاشات، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياتهم، سواء في بعدها العقلي أو في بعدها الواقعي. وإذا كان لكثير من القضايا الجانبية، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو أيديولوجية أو وطنية أو قومية، أن تُناقَش جنبًا إلى جنب بإزاء المنظومة الدينية، فمن منطلق ديني ابتداءً أو بصفتها نتيجة للمنظومة الدينية أو متموقعة في واحد من سياقاتها الفاعلة.
تلك السردية الكبرى التهمت كل السرديات الجانبية، ولم يعد ثمة مدخل أو مخرج لواحدةٍ منها، إلا وله أصل في السردية الكبرى، فهي بمثابة الرَّحم الكبيرة التي خرج منها كل أولئك المواليد، لكنهم بقوا مربوطين بها بحبلٍ سُرّي، إذ لم يُقطع حبل المشيمة ساعة الولادة، بل بقي جزء منه يربط بين الرحم والمواليد. إلى حدّ أصبح معه نقاش أي قضية يستلزم حضورًا للدين أو لتداعيات الدين.
إلا أن المفارقة أو الطفرة التي تجلّت حديثًا، الانتقال بتلك النقاشات من إطارها الفردي إلى سياقها الجمعي، إذ انخرطت مجاميع كبيرة من الناس في تلك النقاشات، ويومًا إثر يوم لا تتوسّع تلك النقاشات كميًا فقط، بل تتعمّق نوعيًا أيضًا، إلى حد أصبحت كبرى القضايا مثار نقاش وسجال يحتدم لحظة بلحظة.
لربما كانت هذه اللحظة من أعمق لحظات المشروع النهضوي العربي، لما تحمله في طياتها من إمكان معرفي جمعي يُراكِم معارفه لغاية إنتاج فيلسوف فردي، قادر على الانتقال من “الأعراض” إلى “الجواهر”، أي قدرته على تقعيد الوحدات الصغيرة التي يقوم عليها معمار الاجتماع السياسي، ومنحها مفاهيمية جديدة غير تلك القائمة، لغاية التأسيس لكينونة جديدة، عبر إحداث إزاحة جوهرانية في الصيغة الإبيستمولوجية لثلاثية: الإله والإنسان والعالَم، بصفتها الوحدات الأساسية التي يمكن للفيسلوف أن يكون فيلسوفًا دون أن يحدث إزاحة معرفية في بنيتها العميقة.
لذا تُصبح ولادة الفيلسوف عملًا مُكلفًا على المستويين الاجتماعي والسياسي، نظرًا لتهديده للنظم القائمة، وفعلًا عسيرًا على مستوى النسق الإبيستمولوجي لما تتطلبه هذه الولادة من قدرة هائلة على إنتاج نسق معرفي يُعيد مَفْهَمَة ثُلاثية: الإله والإنسان والعالَم، مَفْهَمَة جديدة غير تلك القائمة والفاعلة في الاجتماع السياسي.
إلا أن تحضيرات هذه الولادة من آلام ومخاضات تحدث منذ قرنين تقريبًا في العالَم العربي، لذا فإنَّ مسألة ولادة الفيلسوف مسألة كامنة الحدوث، آنًا أو مستقبلًا، فالجموع التي تُناور على التخوم، على الحدّ الفاصل بين الأعراض والجواهر، سيُزَجّ بها وسط النار على يد الفيلسوف إذ يُولد ولادة معرفية، فيتحوّل ساعتئذ إلى أكبر هادم للأبنية القائمة وأكبر بنَّاء أيضًا، فيُحدث بلبلة كبيرة، ستفضي لاحقًا إلى ولادة الأمة ولادة جديدة، بلا شك، على المستوى الحضاري.
دعوني أرتّب الأمور بشكلٍ آخر:
مع بدايات ما اصطلح عليه بـ”عصر النهضة” بدأت جُملة من الأسئلة الشائكة والشائقة تُطرح من بعض المهتمين بالتغيير، حول حالة الخراب التي لحقت بالعالَم العربي، فأهانت وجوده الحضاري. وقد تصاعدت وتيرة هذه الأسئلة ابتداءً من القرن التاسع عشر، وما زالت تتصاعد حتى اللحظة، لا سيما مع المساحات التي وفرتها التطبيقات التكنولوجية الحديثة، إذ انخرط الإنسان العادي في ملحمة السجال والنقاش حول حالة الخراب التي تعصف به، ومحاولة تلمّس أسبابها وأعراضها والنتائج التي ترتبت عليها.
أصبحت الأسئلة التي تُطرح في الكتب والغرف المغلقة والندوات الخاصة ومقتصرة على ثلّة من المهتمين، تُطرح في العلن والفضاء العام، وبإزاء جموع كبيرة. إذ انطوت العوالِم الافتراضية التي وفرتها التكنولوجيـا الحديثـة على أفقٍ غير مُتناهٍ لبسط ما يدور في العقول والقلوب، ويؤثر مباشرة على الواقع المعيش بمراتبه المختلفة.
شيئًا فشيئًا أخذت هذه الأسئلة وما ترتّب عليها من تعدّد في الإجابات، ومن منابع شتّى، بالتوطّن في أذهان الناس، ما هيأها لأيّ إزاحات معرفية كبرى، سيضطلع بأكبرها فيلسوف حُر يهدم كل شيء دفعة واحدة، ويبني كل شيء دفعة واحدة أيضًا. إذ سيُشكّل نقطة فاصلة وحاسمة في مسيرة الأمة المعرفية، ويعبر بها من التاريخ القارّ إلى المستقبل المنشود، مع ما يحتمله هذا العبور من آلام جسام، لا يمكن لحدث الولادة أن يحدث دونها.
إذًا، ثمة وجوه ثلاثة، اقترحتها أعلاه، للإجابة عن السؤال المزدوج أعلاه حول وجود فعل تفلسفي عربي على المستوى الجمعي، ووجود فيلسوف عربي على المستوى الفردي، أولها استنكاري وثانيها استفهامي وثالثها استقصائي، لو أخذت مُجزَّأة لحدث شرخ في الاستيعاب والفهم، لذا من الأولى أخذها مُجتمعة لتشكيل أفق رابع، أفق استبشاري بالأحرى، يحمل:
- بشارة تعميق فعل التفلسف، في جميع المجالات، على المستوى الجمعي وتجويده حتى حدود قصوى، فالنماذج المُبدعة موجودة، لكنها بحاجةٍ إلى تبيئة وتوطين.
- بشارة ولادة الفيلسوف العربي على المستوى الفردي، إذ توسّعت رحم المجال العام إلى حدود قصوى، وأصبحت مُهيأًة، رغم الآلام الكبيرة التي ستحدث، لحدث الولادة التي ستُعيد للأمة ألقها الحضاري من جديد.
[1] صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عن وزارة الثقافة الأردنية سنة 2021
مقالات ذات صلة:
* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
_________________________________
لمتابعة قناة اليوتيوب لأكاديمية بالعقل نبدأ، اضغط هنا
لقراءة المزيد من المقالات، اضغط هنا

